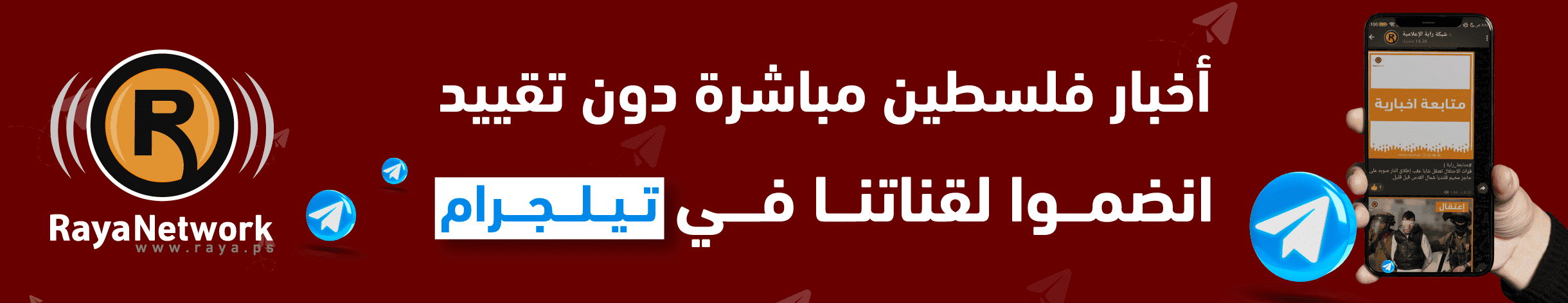البنوك الفلسطينية في عين العاصفة: شريان الاقتصاد يختنق

الكاتب: الدكتور سعيد صبري
في الوقت الذي يقف فيه الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار، لم تسلم البنوك الفلسطينية من تداعيات الأزمة، بل أصبحت في قلب العاصفة، تواجه ضغوطًا متزايدة بين مطرقة الأزمات المالية وسندان التحديات السياسية، لتتحول من جهة فاعلة في التنمية إلى جهة تصارع من أجل البقاء.
تُعد البنوك في أي اقتصاد ركيزة أساسية للاستقرار والنمو، لكن الواقع الفلسطيني المعقد – بفعل الاحتلال والانقسام والأزمات المتلاحقة – جعل هذا القطاع في وضع هش رغم ما يظهر من مؤشرات استقرار ظاهري. فقد أبرز تقرير البنك الدولي لعام 2024 ملامح الأزمة المالية المتفاقمة، من خلال تحليله لمستوى الإنفاق العام واعتماد السلطة على الجهاز المصرفي المحلي، ثم عاد التقرير المُحدّث لعام 2025 ليؤكد خطورة هذه التوجهات، محذرًا من تداعيات مباشرة تهدد الاستقرار البنكي والمالي برمّته.
يتكوّن الجهاز المصرفي الفلسطيني من 15 بنكًا (7 محلية و8 وافدة)، لكن رغم هذا العدد، يلاحظ أن ما يزيد عن نصف التسهيلات المصرفية في بعض السنوات تذهب إلى موظفي القطاع العام، ما يضع البنوك في مواجهة مخاطر مزدوجة كلما تأزمت العلاقة المالية بين الحكومة والاحتلال بشأن أموال المقاصة. وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة التمويل الموجه للمشاريع الإنتاجية 15–20% من إجمالي التسهيلات، في حين تكاد تغيب أدوات التمويل التنموي في القدس بسبب التعقيدات القانونية والسياسية المفروضة على المدينة.
وفي ظل غياب رؤية تنموية متكاملة، تتحول البنوك إلى جهات تمويل استهلاكي، يغلب عليها نمط القروض الشخصية وتمويل السيارات أو المنازل، في وقت تحتاج فيه السوق الفلسطينية إلى استثمارات إنتاجية ومشاريع تشغيلية.
هذا التوجه القائم على ربط التسهيلات بمصادر دخل ثابتة (كرواتب الموظفين) يُسهم من جهة في تقليل المخاطر قصيرة الأجل، لكنه يُضعف من جهة أخرى قدرة البنوك على المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، ويجعلها أكثر عرضة للانكشاف عند أي اهتزاز في التدفقات المالية للحكومة.
ومن جانب آخر، فإن التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي لا تنحصر فقط في علاقة البنوك مع الحكومة، بل تمتد إلى البيئة السياسية والأمنية التي تعيق التحويلات المالية، وتفرض قيودًا إسرائيلية على حركة الأموال، خاصة الشيكل، ما أدى إلى أزمة سيولة حقيقية تعاني منها البنوك، وتضعها تحت تهديد العقوبات أو الانهيار التدريجي في حال استمرت هذه القيود.
كما أن تصاعد أزمة الشيكل المتكدس داخل الجهاز المصرفي، بسبب إحجام البنوك الإسرائيلية عن استقبال الفائض النقدي، يعمق من أزمة السيولة، ويُضعف قدرة البنوك على الإقراض أو حتى الحفاظ على التزاماتها اليومية تجاه عملائها. في الوقت نفسه، تقف سلطة النقد أمام معادلة معقدة بين الحاجة إلى التدخل لحماية الجهاز المصرفي، والقيود المفروضة على سيادتها النقدية.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة المقترضين من موظفي القطاع العام تتجاوز 50% من إجمالي عدد المقترضين، وهي نسبة تعكس مدى ترابط الجهاز المصرفي مع استقرار الرواتب الحكومية. كما أن نسبة المشاريع الاقتصادية الممولة من البنوك في القدس ومحيطها تبقى محدودة للغاية، مما يخلق فجوة تمويلية في واحدة من أكثر المناطق حساسية من حيث الحاجة إلى دعم اقتصادي وسياسي.
ورغم هذه التحديات، لا يمكن إنكار الجهود التي تبذلها البنوك وسلطة النقد للحفاظ على الاستقرار النسبي في النظام المصرفي، من خلال إجراءات احترازية ومخصصات مالية وقيود على الإقراض غير الآمن. لكن هذا الاستقرار يظل هشًا، ومعتمدًا على استمرار التدفقات المالية الخارجية، وعلى قدرة الحكومة على الصمود، وهو أمر بات محفوفًا بالمخاطر.
إن واقع البنوك الفلسطينية اليوم هو انعكاس مباشر للبيئة السياسية والاقتصادية الهشة، وهو مؤشر خطير على عمق الأزمة. ولأن البنوك تمثل شريان الاقتصاد، فإن أي اختناق فيها سينعكس على كل مفاصل الحياة الاقتصادية، من سوق العمل إلى الاستثمار، ومن قدرة الأفراد على الإنفاق إلى قدرة الشركات على النمو.
من هنا، فإن حماية القطاع المصرفي تتطلب تحركًا متكاملًا يشمل:
توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، لخلق مصادر دخل بديلة ومستقلة.
تعزيز أدوات التمويل المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الضغط السياسي والدولي لرفع القيود الإسرائيلية على التحويلات النقدية.
إعادة هيكلة العلاقة بين البنوك والحكومة لتقليل الاعتماد المتبادل المفرط.
بناء أدوات سيادية لتعزيز قدرة سلطة النقد على التدخل الفعّال وقت الأزمات.
إنشاء صندوق طوارئ مصرفي يعزز القدرة على مواجهة الأزمات قصيرة الأجل.
ختامًا، لم تعد أزمة البنوك مجرد مسألة فنية تُعالج بإجراءات مالية، بل أصبحت قضية سيادية بامتياز، تتطلب رؤية استراتيجية وطنية تُعيد تعريف دور البنوك كرافعة للاقتصاد لا كمجرد أداة لتدوير الأزمات. ولا يمكن فصل حماية القطاع المصرفي عن مشروع الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني، الذي يبدأ من التحرر من التبعية المالية ويمر عبر استعادة القرار السيادي وبناء اقتصاد إنتاجي متين.