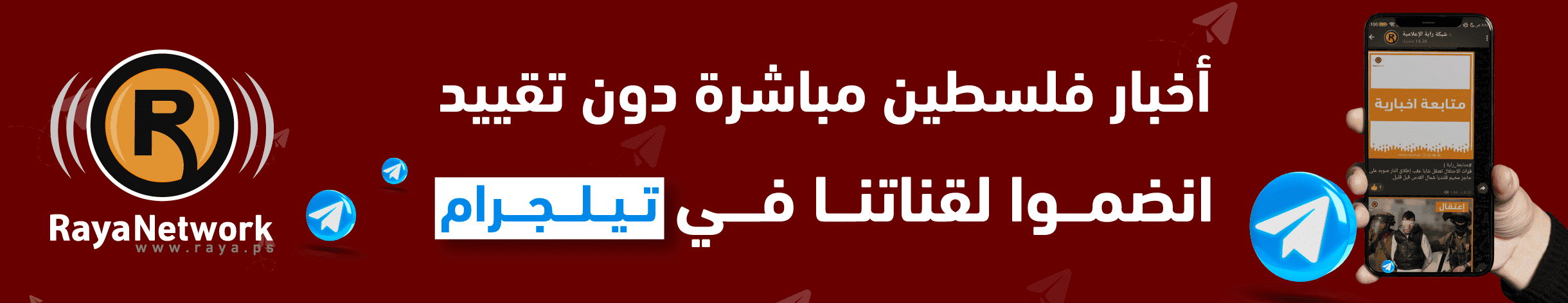أزمة النظام السياسي الفلسطيني
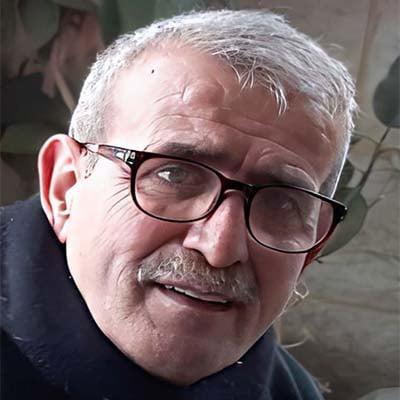
الكاتب: نبهان خريشة
على الرغم من أن النقاش العام يحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية الأولى والأخيرة عن التراجع الوطني والمؤسساتي القائم، إلا أنّ الحقيقة الأوسع تتمثل في أنّ السلطة ليست المكون الوحيد للنظام السياسي الفلسطيني. فالنظام، وفق بنيته التاريخية، يشمل منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها كافة، إضافة إلى حركة حماس التي أفرزتها مرحلة ما بعد الانتفاضة الأولى، وكذلك مكوّنات المجتمع المدني التي لعبت دورًا سياسيًا واجتماعيًا مؤثّرًا عبر العقود. إن هذا التشابك في المكوّنات هو ما يجعل الأزمة الحالية أزمة شاملة لنظام بكامله، وليس لمؤسسة واحدة، أزمة مستعصية تتفاقم في ظل غياب مشروع وطني موحَّد وافتقار الإرادة السياسية الجريئة لإعادة البناء.
السلطة الفلسطينية تمر اليوم بمأزق مركّب تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد وبالحوكمة، ويغذّي كلُّ عنصر منها الآخر في حلقة مفرغة. فملف الفساد المستشري لم يعد يقتصر على الانطباعات العامة، بل تحوّل إلى محور ضغط تمارسه الدول المانحة من خلال اشتراط إصلاحات مصمّمة وفق أجنداتها الخاصة، لا وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني. وعلى الرغم من حاجة الفلسطينيين لإصلاح عميق يحدّ من الفساد ويعيد بناء المؤسسات، إلا أن فرض نماذج جاهزة من الخارج جعل الإصلاح ذاته أداة للهيمنة السياسية، ما زاد من انعدام الثقة بين المواطنين والسلطة.
هذا المأزق يتعمق أكثر بفعل التكلّس السياسي الناجم عن غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية منذ نحو عشرين عاماً، وهو أمر أحدث انفصالاً كاملاً بين القيادة والشعب، وحوّل البنية السياسية إلى شبه نظام مغلق لا يدخل إليه دم جديد ولا تتجدد فيه الشرعيات أو تتنافس فيه البرامج. الأدهى من ذلك أن نمط الحكم بات أقرب إلى الشمولية، حيث تتركز السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد شخص واحد، فيما جرى إلغاء المجلس التشريعي، وتحويل صلاحياته الدستورية إلى قرارات بقانون تصدر عن الرئيس، في تجاوز واضح لروح النظام الأساسي وتحويله إلى مجرد نص رمزي لا يُحتكم إليه عندما تتعارض متطلبات السلطة مع مقتضيات القانون.
يضاف إلى ذلك كله تراجع المكانة الإقليمية والدولية للسلطة الفلسطينية، بحيث انحسر دورها كفاعل دبلوماسي في القضية الفلسطينية، بعد أن كانت في السابق نافذة للعالم على الوضع الفلسطيني. هذا التراجع جعل السلطة شبه غائبة عن النقاشات المحورية المتعلقة بمستقبل غزة والضفة الغربية، وسمح لأطراف إقليمية ودولية أخرى بأن تمسك بزمام المبادرة السياسية. لم تعد السلطة قادرة على صياغة موقف فلسطيني يُحسب له حساب، ولم تعد المرجعية التي يلجأ إليها العالم في القضايا المصيرية، وهو أمر ألحق ضرراً بالغاً بمكانتها وشرعيتها والتالي بمكانة القضية الفلسطينية.
وفي ما يتعلق بفصائل اليسار الفلسطيني، فقد وجدت نفسها هي الأخرى في قلب الأزمة، لكنها أزمة ذات طابع وجودي. فبعض هذه الفصائل اختار الالتصاق بالسلطة الفلسطينية حفاظاً على مكاسب مالية واستمراراً في الوجود ولو شكلياً، رغم فقدانها قواعدها الشعبية وتحوّل بنيتها إلى إطار بيروقراطي يفتقر إلى الحيوية. قيادات هذه الفصائل تكلّست بدورها، وظلت ثابتة في مواقعها سنوات طويلة دون تجديد أو مراجعة نقدية. أما الفصائل اليسارية التي عارضت السلطة وحركة فتح، فلم تستطع أن تخلق تأثيراً حقيقياً في مجريات الأحداث، وبقيت مواقفها السياسية أسيرة البيانات الصحفية أو التصريحات المتلفزة التي لا تصنع سياسات ولا تغيّر وقائع على الأرض. لقد انسحب اليسار عملياً من دوره التاريخي كقوة نقدية صاحبة رؤية اجتماعية وطنية، وأصبح وجوده أقرب إلى الظل.
غير أن المأزق الأكبر يبقى مأزق حركة فتح، التي تعدّ العمود الفقري للسلطة ومنظمة التحرير في آن واحد. تعيش فتح أزمة عميقة متعددة المستويات. فالتيار التاريخي للحركة فقد الكثير من زخمه الثوري منذ أن تحولت الحركة من حركة تحرر وطني إلى حزب مرتبط عضوياً بالسلطة، يعتمد بقاؤه على بقاء مؤسساتها. هذا الارتباط الوثيق جعل فتح تتحمل أعباء إخفاقات السلطة دون القدرة على فصل ذاتها عنها أو تقديم مشروع بديل يعيد لها مكانتها كقائد للحركة الوطنية.
وتعاني الحركة أيضاً من أزمة بنيوية داخلية، تتمثل في غياب الديمقراطية التنظيمية وتهميش الأطر القيادية الوسيطة واحتكار القرار السياسي والتنظيمي من قبل دائرة ضيقة، الأمر الذي عطّل تجديد القيادات الشابة ودفع الكثير من الكوادر إلى الابتعاد أو الانضمام إلى تيارات موازية. كما تواجه فتح أزمة خطاب، فهي لم تعد تمتلك برامج سياسية واضحة تستطيع من خلالها مخاطبة الشارع الفلسطيني أو استعادة ثقة الجيل الجديد الذي نشأ على واقع مختلف بالكامل عن واقع انطلاقة الحركة. ويضاف إلى كل ذلك أنّ فتح اليوم تعاني من انقسامات داخلية غير معلنة، بين مراكز قوى تتنافس على النفوذ داخل الحركة والسلطة معاً، ما جعلها ضعيفة من الداخل وغير قادرة على توحيد صفوفها أو فرض حضور سياسي قوي خارجياً.
منظمة التحرير الفلسطينية، فهي الأخرى تمرّ بأزمة عميقة جعلت دورها التاريخي في تمثيل الشعب الفلسطيني يتلاشى تدريجياً. فعلى مدار السنوات الماضية، تم تهميش مؤسسات المنظمة لصالح مؤسسات السلطة، وتحولت دوائر المنظمة إلى هياكل شكلية لا تملك تأثيراً حقيقياً على القرار الوطني. خضعت المنظمة لعملية إحلال صامت، جرى فيها نقل صلاحياتها التنفيذية والمالية إلى السلطة، ما أفقدها دورها التمثيلي الجامع للفلسطينيين في الداخل والشتات. كما أنّ الفصائل المنضوية في إطارها لم تعد قادرة على لعب دور توازني أو مراقب لسياسات السلطة. ومع تراجع حضور المنظمة، تراجعت معها المرجعية الوطنية الموحدة التي شكّلت سابقاً الركيزة الأساسية للنضال الفلسطيني.
وفي موازاة ذلك، تعيش حركة حماس أزمة لا تقل تعقيداً، لكنها ذات طبيعة مختلفة. فمنذ أن سيطرت على قطاع غزة عام 2007، وجدت الحركة نفسها محاصرة بين إدارة واقع يومي بالغ الصعوبة بفعل الحصار والحروب المتكررة، وبين سعيها للتمسك بشرعية “المقاومة” التي تسوّغ من خلالها استمرار سلطتها. هذا التناقض خلق أزمة هوية داخل الحركة نفسها: هل هي حركة مقاومة أم سلطة حاكمة؟ هل تُقدّم أولويات الإدارة اليومية على مشروع المقاومة أو العكس؟ هذا التردد جعل سياساتها الداخلية متقلبة بين البراغماتية والتشدد، وأضعف قدرتها على بناء استراتيجية وطنية مستقرة.
أما على مستوى العلاقات الفلسطينية الداخلية، فتعاني حماس من أزمة ثقة مع غالبية الفصائل والقوى الوطنية. فقد فشلت اتفاقيات المصالحة المتتالية في إنهاء الانقسام، لأسباب تتعلق بالحسابات السياسية بين حماس وفتح، لكن أيضاً بسبب عدم استعداد حماس لتقديم تنازلات جوهرية تتعلق بسلاحها أو بنيتها الأمنية. العلاقة بين حماس ومنظمة التحرير ظلت بدورها علاقة تنافس على الشرعية، إذ ترى الحركة أن المنظمة لم تعد تمثل جميع الفلسطينيين، بينما ترى القيادة الرسمية أن دخول حماس إلى المنظمة يستلزم التزامات سياسية لا ترغب فيها الحركة. كما أن علاقة حماس مع المجتمع المدني والنخب السياسية في الضفة وغزة تأرجحت بين الشراكة الرمزية والهيمنة، ما جعل من المشهد الداخلي أكثر هشاشة.
وفي السنوات الأخيرة، تعمقت أزمة الحركة نتيجة تعقّد علاقاتها الإقليمية. فمحاولاتها الدائمة للتموضع بين محاور متصارعة في المنطقة أدت إلى تناقضات في مواقفها السياسية، وأثرت على قدرتها على بناء تحالفات فلسطينية مستقرة. كما أن إدارتها لغزة واجهت انتقادات داخلية واسعة بسبب سياسات فرض الضرائب والتضييق على الحريات، الأمر الذي جعل جزءاً من قواعدها الشعبية يعيد النظر في موقع الحركة داخل المشروع الوطني.
إن الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني هي أزمة بنيوية شاملة، لا يمكن اختزالها في سلوك سلطة أو فصيل بعينه. هي أزمة غياب المشروع الوطني، وأزمة مؤسسات فقدت شرعيتها، وأزمة قوى سياسية لم تجدّد نفسها، وأزمة شعب يبحث عن قيادة قادرة على تمثيله وصون حقوقه واستعادة قضيته من التآكل الدولي والإقليمي. إعادة بناء النظام السياسي باتت ضرورة وجودية، لكنها لن تكون ممكنة من دون إرادة جماعية وشجاعة سياسية تعترف بالأزمة أولاً، وتبدأ من إعادة الاعتبار لصوت الشعب وحقه في اختيار قياداته وصياغة مستقبله.