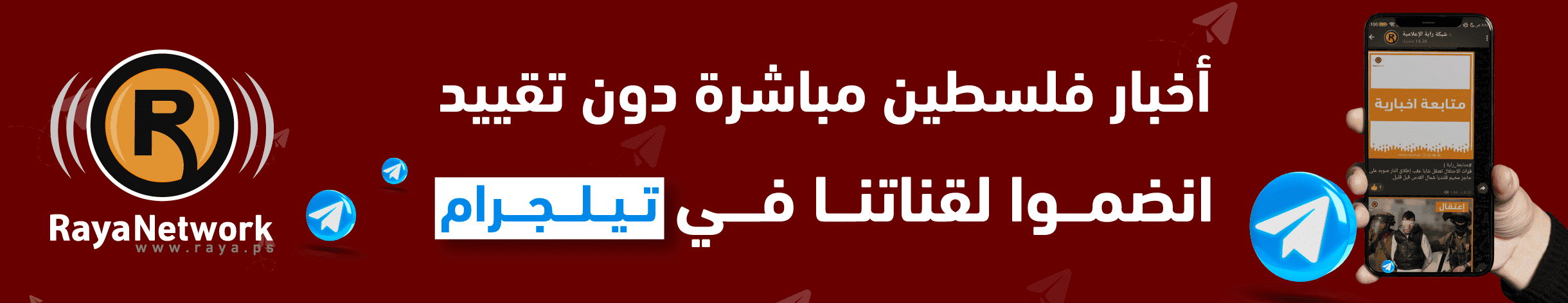20 ألف شيكل... سقف الكاش أم اختبار الثقة؟

الكاتب: د. سعيد صبري
بين الانضباط المالي والحاجة إلى السيولة اليومية، يقف الاقتصاد الفلسطيني أمام منعطف جديد عنوانه مشروع قانون “خفض استخدام النقد”. القانون الذي يضع سقفًا قانونيًا للتعاملات النقدية عند عشرين ألف شيكل، يفتح الباب أمام نقاش واسع حول جاهزية السوق، وثقة المواطن بالنظام المالي، ومستقبل العلاقة بين الورقة النقدية والشاشة الإلكترونية.
طرحت سلطة النقد الفلسطينية مؤخرًا مشروع قانون جديد بعنوان “خفض استخدام النقد في فلسطين”، يهدف إلى الحد من التعاملات النقدية المباشرة وتنظيم تداول الكاش في السوق المحلية. وينص المشروع بوضوح في المادة (4) على أنه "يحظر الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها بأي حال من الأحوال عن (20,000) عشرون ألف شيكل أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين." وهي مادة تختصر فلسفة القانون في جملة واحدة: ضبط النقد عبر سقف محدد لا يمكن تجاوزه إلا بوسائل دفع إلكترونية أو مصرفية.
القانون لم يُقرّ بعد، وما زال في مرحلة المشاورة العامة، وهي فرصة مهمة — وربما نادرة — لفتح نقاش وطني حول فلسفته وآليات تطبيقه وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. فالمسألة لا تتعلق بالتحكم في النقد فقط، بل في العلاقة بين المواطن والنظام المالي، وبين الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الشعبي الذي يعيش على السيولة اليومية.
اليوم، يعيش الاقتصاد الفلسطيني مفارقة حقيقية: وفرة نقدية في البنوك وشح في أيدي الناس. تتكدّس المليارات من الشيكل في خزائن المصارف بسبب القيود الإسرائيلية على التحويلات النقدية، بينما يواجه المواطن والتاجر صعوبة في السحب أو التداول. هذا الخلل ولّد ثقافة نقدية تقوم على الاحتفاظ بالسيولة كوسيلة أمان نفسي، لا كأداة للتبادل الاقتصادي. ومن هنا، لا يمكن قراءة مشروع القانون بمعزل عن أزمة الثقة العامة في النظام المالي. فالموظف الذي يحتفظ بنقده في البيت، والتاجر الذي يفضّل الدفع المباشر، والمواطن الذي يخشى التحويل البنكي — جميعهم يعكسون غياب الثقة أكثر مما يعكسون حبًّا للنقد ذاته.
لكن رغم هذه الإشكالات، لا يمكن تجاهل النية الإصلاحية الواضحة في القانون. فهو يسعى إلى تعزيز الشفافية، مكافحة التهرب الضريبي، والحد من غسل الأموال، إضافة إلى إدخال مزيد من الفاعلين في دائرة الشمول المالي. ومع ذلك، تبقى الأرقام مؤشراً مقلقًا: فبحسب تقارير سلطة النقد، لا يتجاوز من يمتلكون حسابات مصرفية في فلسطين 50% من السكان البالغين، بينما لا يستخدم خدمات الدفع الإلكتروني سوى نحو 30% فقط. أي أن نصف المجتمع تقريبًا لا يزال خارج النظام المالي الرسمي، ما يجعل أي تشريع يقيد الكاش سابقًا للبنية الاجتماعية والتقنية القائمة.
من جانب آخر، فإن القطاعات النقدية الحساسة ستكون الأكثر تأثرًا من تطبيق القانون الجديد. فإلى جانب العقارات والإنشاءات وتجارة الذهب والسيارات، تبرز أيضًا محطات الوقود والغاز كأحد أهم القطاعات المتضررة، نظرًا لاعتمادها شبه الكامل على السيولة اليومية وتعاملها المباشر مع الجمهور بمبالغ متفاوتة لكنها كثيفة. هذه القطاعات تمثل شرايين الحركة النقدية في السوق، وأي تقييد مفاجئ للتعامل النقدي فيها قد يؤدي إلى ارتباك في عمليات التحصيل والدفع، ويستدعي حلولًا انتقالية أكثر مرونة قبل الإلزام بالتطبيق الكامل.
لهذا، فإن الطريقة المثلى للتعامل مع مشروع القانون لا تكون عبر الرفض أو الإسراع في الإقرار، بل عبر التدرج والتكييف. أولاً، ينبغي تهيئة الأرضية الرقمية والمالية عبر توسيع انتشار المحافظ الإلكترونية، وتخفيض رسوم التحويلات البنكية، وتبسيط إجراءات الدفع غير النقدي. ثانيًا، يجب تعزيز الثقة بين المواطن والبنك عبر شفافية أعلى وحماية قانونية أقوى للودائع والمعاملات، حتى يشعر المواطن أن التحويل الإلكتروني لا يقل أمانًا عن النقد الذي يمسكه بيده. ثالثًا، على السلطة النقدية أن تدرس استثناء القطاعات الحساسة مثل العقارات، الإنشاءات، الذهب، السيارات، والوقود والغاز من التطبيق الفوري، لأنها تمثل العمود الفقري للتعاملات اليومية في السوق الفلسطينية.
إن فرض سقف نقدي دون تهيئة البنية المالية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها نشوء سوق رمادية تتداول النقد خارج النظام المصرفي، أو لجوء الناس إلى عملات بديلة كالشيكل النقدي غير المسجل أو حتى الدولار والدينار. وهنا تتحول الفكرة الإصلاحية إلى عبء تنظيمي يزيد من تعقيد الأزمة بدل حلّها. فالقوانين المالية — كما التجارب الدولية — لا تُقاس بنصوصها، بل بمدى ملاءمتها لواقع السوق وثقافة الناس.
إن مشروع قانون خفض استخدام النقد يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد أكثر شفافية وانضباطًا، لكنه في جوهره اختبار لمدى جاهزيتنا للتحول المالي الحقيقي. فالتشريعات مهما بلغت دقتها لا تنجح إن لم تُبنَ على ثقة المجتمع، ولا تترسخ إن لم تُرافقها أدوات تطبيق واقعية. إن ضبط الكاش ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لإدارة اقتصاد حديث قائم على الكفاءة والثقة، لذلك فإن الطريق الأمثل ليس بتقييد النقد بقرارات فوقية، بل بإقناع المواطن بأن النظام المالي الحديث يخدمه ويحميه.
توصي التجربة الفلسطينية بأن يرافق أي تطبيق للقانون برنامج وطني موسع لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع انتشار المحافظ الإلكترونية، وتخفيض تكاليف التحويلات، وتوفير ضمانات قانونية للمستهلكين. كما يُستحسن أن تُمنح القطاعات النقدية الحساسة — كالعقارات والذهب والمقاولات ومحطات الوقود والغاز — فترة انتقالية تسمح بالتدرج في التنفيذ بدل الصدمة المباشرة. بهذا التوازن بين الانضباط والثقة، وبين الإصلاح والتدرج، يمكن لمشروع القانون أن يتحول من ورقة تنظيمية إلى أداة تغيير في سلوكنا المالي، وأن يفتح الباب نحو اقتصاد رقمي فلسطيني أكثر شفافية وعدالة.
فالمال في النهاية ليس رقماً على شاشة ولا ورقة مطبوعة، بل مرآة لعلاقة المواطن بدولته. وإذا لم تُبنَ هذه العلاقة على الثقة، فإن أي سقف للكاش سيبقى نظريًا — لأن الاقتصاد الحقيقي، كما الإنسان، لا يعيش إلا بالتوازن بين الأمان والحرية.